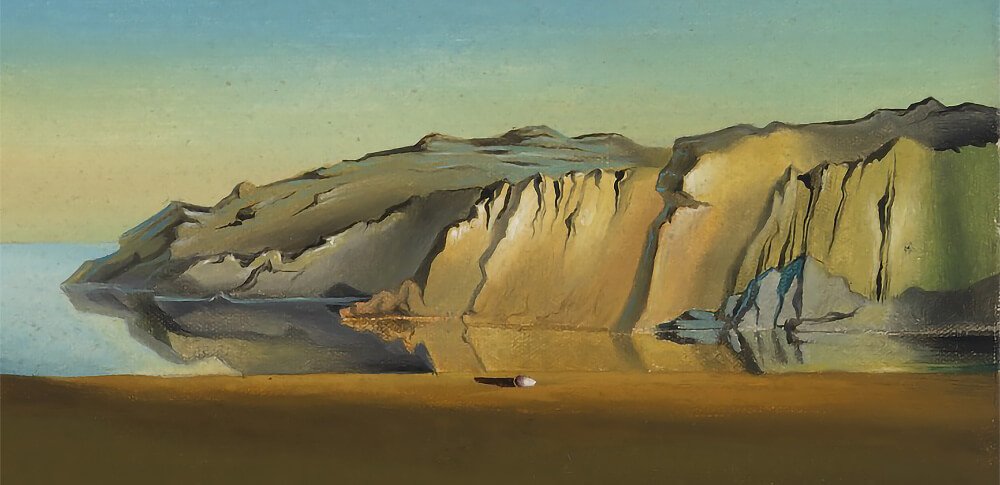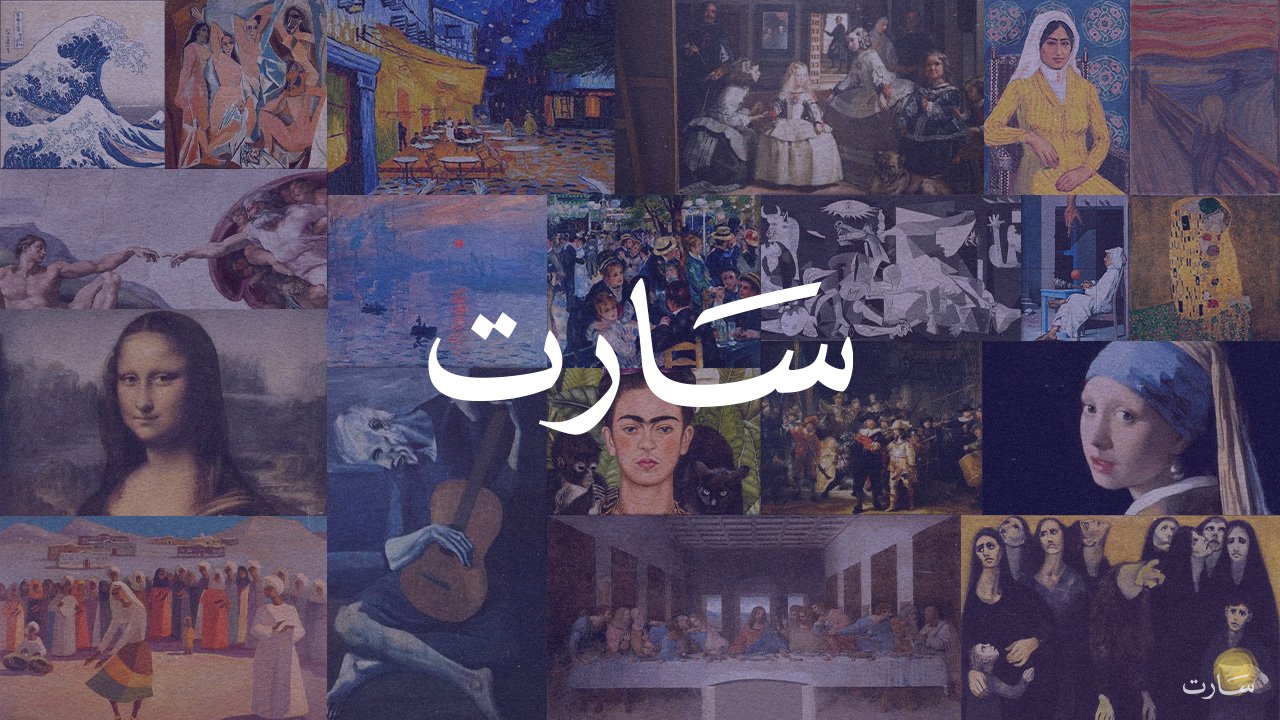تشارلي تشابلن من فيلم “الطفل 1921”
أسماء الطرابلسي
إذا نظرنا إلى المسرح نظرة ماكرو شموليّة من حيث الجانب المفاهيمي لتعدّدت الصّياغات والقراءات فلا يمكننا القبض على تعريف موحّد يستقرئ جميع زوايا الفن الرّابع على اعتباره كيانا متنوّعا واستمراريا، غير أنّ جلّ النّقاد والذّاقة قد أجمعوا على أنّ المسرح سبيلا للتّصريح عن المكنونات وأسلوبا لصياغة المعاني ونهجا للبوح عن الاختلاجات ما وراء اللّغة المنطوقة بأدوات مدروسة تستثير ردّ الفعل الجمالي المجاوز لكلّ الأطر.
ولكن يبدو أنّ المسرح الصّامت قد أبدا جرأة مخصوصة في التّعامل مع معالم الوجه وتقاسيم الجسد للوصول إلى بناء الشّخصيّة المتناسبة مع تعبيراتها وطباعها والفضاء السّينوغرافي العام بما فيها من أقنعة وعرائس وملابس وماكياج من أجل بلوغ رؤية إبداعيّة مخصوصة في الإخراج السّمعي البصري وتناول مشهديّة الصّورة بنيويّا وتأويلها دلاليّا لاستمالة الجانب التّخييلي للمتفرّجين وفكّ شيفرات العرض..
"إنّ الكلمات ليست كلّ شيء، ولا تقول كل شيء، ويجب أن يُستكمل المعنى بالحركة التّشكيليّة الجسديّة شرط ألّا تكون هذه الحركة ترجمة للكلمات، فحقيقة العلاقات بين الأشخاص تقرّرها الإشارات والأوضاع والنّظرات ولحظات الصّمت..." هكذا عبّر المخرج الرّوسي ماييرخولد عن العروض الفرجويّة القائمة على خطابة الجسد والصياغة الركحيّة المؤثّثة بخصائص بصريّة تحرّك الحدث الدّرامي واللّحظات الانفعاليّة الّتي تبني وجها من التواصل غير اللفظي.
وإن اعتُبر الصمت مطلبا إجرائيا بين ما هو جمالي وما هو نفسي، فإنّ العرض الصامت لطالما تطلّب نسقاإيقاعيّا بين متانة الفكرة وبساطة الإنجاز فيتحوّل من التجريد إلى التطبيق، لذلك تكون فاعليّة الجسد المحمّل بالرموز والسمات بين ما يطلقه الوجه من تعابير وما يوحي به الجسد من حركات وإيماءات، تُنشأ عند تفاعلها دلالات مشتركة بين الجمهور والممثل كلّ حسب تنشئته الاجتماعية والذاكرة الجمعيّة والعرف، فيكون ذلك العرض فرصة فنّيّة لنقد الإرث الثقافي المعروف بالجمود والرتابة نقدا من حيث حضور الميثيولوجيا (الأساطير والفلكلور الشعبي).
ولعلّ الكوريغرافيا المسرحيّة القائمة بين النّص والأداء تجعل الممثّلين أفكارا وقضايا تتحرّك في المطلق من حيث الدّال والمدلول مرتدية أثواب الرموز فتصيّر بذلك جماليّة إيقاعيّة جامعة بين الثنائيات المتضادّة (المقدّس والمدنّس، الجميل والقبيح...) بغية التأسيس للكوني ليخلد العمل ويدوم ولعلّ ذلك ما يفسّر قول فيشر "إنّ الفنّ لم يكن ضروريا في الماضي فحسب وإنما سيبقى كذلك في المستقبل وعلى الدّوام" وهذا إقرار صريح على أنّ التفنّن مدّ للإبداع الإنساني نحو التّجلّي والانكشاف وهو منشأ للتّأثير وتعدّدية القراءات والتأويلات...
فيما يحضر الجسد في الإرث الفلسفي الذي عالج إشكالية تواجده بأبعاده التاريخانيّة منها والأنثروبولوجيا والفينومينولوجيا، فبين الخطيئة والعفّة وبين ما هو فطري وما هو مكتسب وبين بعديه الطبيعي والثقافي نجد مفهوم الجسد يحضر بتمثلات عدّة في الفنّ الرابع فكيف إذا ما كان صامتا...
على غرار النموذج الأفلاطوني الّذي حقّر من قيمة الجسد وجرّده من كافة معانيه بل واعتبره "وزرا" يثقّل على كينونة الانسان في مسار بلوغه مرحلة الكمال وصيد الحقيقة والذي اعتبره أفلاطون قبرا للنفس وسجنا لملكة العقل الخالدة، جاءت على إثرها فلسفات متباينة حدّ التناقض ناقضت الجسد وجعلته تحت المجهر منها فلسفة "الجسد الآلة" لديكارت والّذي اتّبعه سبينوزا بنزعته الأحاديّة، أما كلود برنار فقد انتصر إلى "أنّ الجسد آلة ومقياسا للتّجارب"، كذلك لاميتري الّذي "اختزله ماديا" ثمّ "فلسفة الجسد الفينومينولوجيا" مع هوسرل ولفيناس وميرلوبونتي الّذي يقرّ بأنّ "الجسد والروح وجهان لعملة واحدة" غير أنّ نيتشه قد جاء بفلسفة تلغي التّصوّرات المثالية لقراءة الجسد واعتبر أنّ الجسد هو جزأ لا يتجزّأ من تركيبة الإنسان بل وراهن على أنّ "الجسد هو العقل الأكبر مقابل العقل الصّغير الّذي هو الوعي".
يقتضي التمثيل الصّامت بالضّرورة مرونة وسلاسة في التعامل مع فيزيولوجيا الجسد بما فيه من تفاصيل خلقيّة تأسّس مزجا بين ما هو متناسب وما هو متضارب مع إيقاعات الموسيقى وتعبيرات واضحة الأسلوب حسّيا وماديا، فيتكلّم الجسد حسب سيرورة ونسق النّصّ الدراماتولوجي من ناحية وحسب التركيب التشريحي لتقاسيمه (في التعبير عن حالاته من خلال دراسة العضلات والحواس كنوافذ التقاط واستقطاب للرسائل) من ناحية أخرى وفي هذا السياق يقول لوسيان ساموساتار "يجب أن تتوافر له معرفة سابقة بالموسيقى والميثيولوجيا وعليه أن يتمتّع بذاكرة حادّة وحساسية مرهفة وجسم متناسق رشيق يجمع بين القوة العضلية ومرونة الأطراف".
قد يثور الجسد ويلاين أحيانا ويجامل فيتناسق بثباته وتذبذبه بين المكشوف والمستور لتكتمل الصّورة المعروضة في محاولة لخلق التوازن البصري بين ما هو دقيق مكتوب وما هو مرتجل وليد للصّدفة لما له من جمالية ودلالة على مستوى بلوغ النوايا الباطنة وتصوّر الخطاب الأخرس لتحقيق الفعل التّواصلي واستيعاب الأفكار المتوالدة.
"إنّ الأشياء التي لا يمكن التعبير عنها بالكلمات يمكن التعبير عنها بالجسد" هكذا عبّر الفنان الفرنسي الشهير مارسيل مارسو والمتخصّص في فن الـ "ميم" إذ يقول في الغرض "الميم هو لغة للعبور من الحدود والجدران"، ففي التّخلي عن اللغة الشفوية تركيز على الخصائص البصريّة ولعلّ من أشهر العروض الصامتة التي عرفتها الذّاقة عروض تشارلي تشابلن التي قام باخراجها وكانت له فيها بطولة مطلقة إذ يعتبر هذا الصنف "ميم موضوعي" حيث يحكي قصص واقعية من بينها The Kid (الصبي) وModern Times" الزمان الحديث" و The Gold Rush" منجم الذهب"...
لئن اعتُبرت الحركة كما اللغة تقوم على تشغيل مكونات السينوغرافيا التي تعمل أساسا على الإيحاء الدلالي والايماء باعتباره علامة أو سمة أو إشارة تتوظّف وفقها الذات داخل المشهد المسرحي وتنحت تفاصيلها لتخرج الصورة متكاملة المعالم، فإنّه من المعلوم أنّ خطابة الجسد في المسرح تتيح للجمهور تجربة فريدة من نوعها حيث يمكنهم الانغماس في عوالم الشخصيات والقصص بشكل أعمق فهي تسهم في تحفيز مخيّلة الجمهور وتجعلهم يشعرون بالانتماء إلى العرض.

مارسو، المعروف بشخصية "بيب"، استخدم تعابير الوجه وحركات الجسد لنقل مشاعر معقدة دون كلمات.
فإذا انطلقنا من فكرة تصميم العرض الصامت لتوصّلنا إلى علاقته بالسيناريو وذلك بدءً من تفسير النص إلى غاية تجسيده على الخشبة فيما تستند هذه العملية إلى خطوات منتظمة ومنسّقة بين أدوات السينوغرافيا (الممثلين، والإضاءة، والأزياء، والماكياج والأكسيسوارات والديكور والمؤثّرات الصوتية...)، كذلك الأمر في علاقته بالممثل حيث ترتكز بالأساس على اختيار الممثلين مع إجراء التمارين بصورة مستمرة (البروفا أو الكاستينغ).
بما أنّ الحكاية أهم عنصر لبناء العرض الصامت يحاول الممثّل أن يوصل الأحداث بأبعادها ومكوناتها سواء كانت ظاهرة مباشرة أو مبطنة مشفّرة، طبيعية كانت أو اصطناعية تتراوح بين ما هو ثابت وما هو متغيّر، ويكون ذلك بانتهاج تقنية الحركة الايمائية القصدية الواعية فتُنتفى عندها العشوائية وذلك من خلال طريقة الوقفة والحركة والإشارة عند التجسيد فالتيك التكرارية التي ترفقها أفعال السكون الفوري تعبّر عن الفعل التهريجي الكوميدي أمّا السّكنات والحركات المتراخية البطيئة تدلّ على الفعل المأساوي الذي يسوده لحظات التأزم في الحبكة.
وقد وظّف بيتر بروك في إخراجه لكثير من عروضه المسرحية عمى التمثيل الصامت بطريقة جزئية، أي في مشاهد درامية معينة داخل عروضه المسرحية التي استعمل فيها منهجا يعتمد على توظيف مجموعة من التقنيات الإخراجية التي استلهمها من مخرجين آخرين تناصا وتضمينا وتجريبا.
ويعزّز المسرح الصامت الابتكار والإبداع في التمثيل والإخراج، حيث يضع تحديات جديدة أمام الفنانين لتصميم تجارب مسرحية مثيرة قائمة على الإيقاع الحركي على اعتباره محدّدا لحركات السينوغرافيا بما فيها من تلاعب بصري بين حركات الضوء والظّلّ وحركات الصوت مع حركات الفعل التمثيلي، بهدف توحيد مكوّنات التشكيل البصري المتمثّلة في الخط والشكل والكتلة واللون والفراغ التي تتجانس مع جسد الممثّل عند قيامه بالفعل أو ردّ الفعل إمّا في حالة المبالغة في الحركة أو في حالة السكون، فللتعبير عن حالة الحزن يتوسّل المسرحي وضعيات معيّنة شأن انكماش الكتفين أو انخفاض الرأس حيث تبرز هذه الإشارات البدنية حالة الخجل أو الخوف دونما الحاجة إلى الإفصاح عنها باللفظة.
ويشارك الماكياج في بناء المعنى حيث يساعد على التمييز بين الوجهين الضاحك والباكي وذلك عن طريق كيفيّة استخدامه وشدّته اللونية فإمّا تكون زاهية مبهجة أو مضخّمة لملامح الوجه قصد اكسابها طابعا من الفكاهة والتهريج أو استخدام ألوان قاتمة تضفي موجات الحزن فتزيد في صورية الفعل التراجيدي كما يمكن أن يساعد أيضا في إيجاد شخصيات خيالية (المخلوقات الفانتازية) وذلك مع إضافة بعض الأقنعة التي تساعد على شدّ انتباه المتفرجين.
إذ أنّ تأثيرات الإنتاج المسرحي في الآونة الأخيرة باتت تستمدّ فاعليتها من عظمة المادة الدراماتولوجبة وقدرتها على الاقتحام الفني والجمالي للمناطق الممنوعة أو القابلة للتفجّر وتحريك الراكد وهزّ الثوابت وحرصها على انطاق المسكوت عنه وفتح نوافذ انطلاق المكبوت والمقموع السياسي والاجتماعي النفسي وكلّ ذلك أتاح للمجتمعات أن تتأمّل ذاتها في حالة من الانكشاف والتّعرّي حتّى وإن جاء هذا الانكشاف من خلال الأقنعة والرموز الدلالية رموز فصيحة تكاد من الإفصاح أن تتكلّم...
لقد أضحى الفنّ الرابع صرحا فنّيا تتفاعل معه الشّعوب بلغاتهم ومعتقداتهم وثقافاتهم من أجل إرساء الإنساني في الإنسان وهو ما جعل الفيلسوف الفرنسي المعاصر "أندري مالرو" يقرّ بأنّ "الفنّ للإنسان..." هذا الانسان معقّد التركيبة والسّلوك لطالما اعترضته صعوبات واحراجات عديدة تجعله يقف أمام سراديب قضايا منها المعروضة ومنها التي عجزت الفنون المعاصرة الحسم فيها أو إيجاد حلول نهائية لها، لذلك يظلّ هذا الانسان سرّا مجهولا ويظلّ باب الفنّ دوما مفتوحا للنقاش والنقد...